أحمد الصياد في روايته «درويش صنعاء»: شاهدٌ على حرب مستمرة منذ خمسين عاماً
المخا تهامة - Thursday 06 September 2018 الساعة 09:27 pm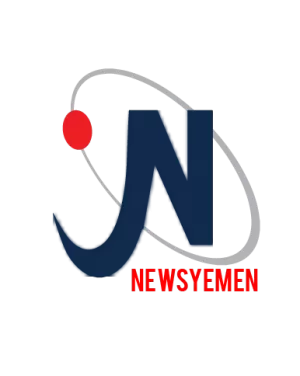 نيوزيمن، نقلاً عن «القدس العربي» - أحمد الأغبري:
نيوزيمن، نقلاً عن «القدس العربي» - أحمد الأغبري:
مَن يقرأ رواية «درويش صنعاء» للكاتب والدبلوماسي اليمني أحمد الصياد، يشعر بأن الانتكاسة السياسية اليمنية التي أعقبت النصر العسكري لملحمة فك حصار السبعين يوماً عن صنعاء في ستينيات القرن الماضي، بقيت تنخر في جسد الجمهورية وتحُول بينها وبين التأسيس لدولة مدنية حديثة وصولاً إلى ما آلت إليه البلاد حالياً.
26 سبتمبر
تُمثل هذه الرواية الصادرة في 139 صفحة عن «دار العلوم ناشرون» في بيروت، شهادة جديرة بالقراءة المتأنية عن الحركة الوطنية الثورية اليمنية، التي أسهمت في فك حصار الملكيين والمرتزقة لصنعاء منذ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 1967 وحتى الثامن من فبراير/ شباط 1968؛ وهي الحركة التي أنقذت الجمهورية الوليدة في اليمن من موت محقق حينها، وأعادت الاعتبار لثورة 26 سبتمبر 1962، التي كانت على وشك الانكسار؛ ليمثل فك حصار صنعاء انتصارا لتلك الثورة، وتعميدا شعبيا لها، ذلك أن الشعب بكل فئاته وأطيافه ومناطقه شارك في صناعته، وبالتالي اكتسبت تلك الثورة بانتصارها العسكري صفتها الشعبية، إلا أن ما شهدته عقب انتصارها من انتكاسة سياسية، أصاب تلك الثورة في مقتل، من خلال ارتهان السلطة للثقافة الطائفية والمناطقية والفئوية؛ وهي الانتكاسة التي ظلت تستنزف عافية الجمهورية، وصولا إلى الحرب المستعرة حاليا، في ما صارت الجمهورية أشبه بعباءة لنهج عصبوي بقيت تتوارثه سلطة عقيمة.
كان الكاتب دقيقاً في حرصه على عدم تجاوز الواقع، وفي تماهيه ـتماماً- مع ما حدث، وكيف لا؟ وقد كان واحدا من صُناع ذلك الحدث، إذ كان حينها واحدا ممن أسهموا في فك الحصار، ولهذا لم نستغرب من كل ذلك الانثيال لمشاعر الحماس والفرح والألم في ثنايا الموقف الثوري، الذي بقي يفيض بغزارة بين سطور النص الروائي، ذلك أن الكاتب كان، وهو يكتب يعكس واقعا عاشه، ويكتب شهادته عنه؛ ولهذا نجد فلسفته للثورة تحضر في الحوار على ألسنة معظم شخوصها، التي شغلت حواراتهم معظم مساحة النص. وتظهر رؤية الكاتب واضحة في حديث (أبو أروى) في ما نرى حماسه وتطلعه في اندفاع وشجاعة (غُمدان) أما تماهيه القيمي مع الوعي الإنساني فجسدته شخصية (برهان) المتصوف.
الملحمة والمأساة
ارتكز بناء الرواية وحدثها الدرامي كثيرا على شخصية (برهان) الذي جاء منه اسم الرواية؛ فمعه، في (الجامع الكبير) في صنعاء، بدأ السرد، وباستشهاده في (ميدان التحرير) انتهت الرواية.
كان (برهان) القادم من خارج اليمن، شاهدا على (ملحمة الانتصار) و(مأساة الانكسار) التي أعقبت النصر، وقد استهلتْ به الرواية سردها في بيئة الملكيين داخل المدينة القديمة، بدءا بلقائه بالملكي الكهنوتي (حنتش)، ومن ثم انتقلت به الرواية بواسطة الشاب المقاوم (غُمدان) إلى بيئة المعسكر الجمهوري، وهناك في (بيت الجمهورية) الذي كان يلتقي فيه بعض قادة المقاومة الشعبية من أطياف اليسار اليمني على ما يبدو… عكست حوارات (أبو أروى) مع (برهان) الخطاب القيمي والفكري، الذي استند إليها ذلك المعسكر في ملحمته لفك الحصار عن مدينة. تنقلت الرواية بين يوميات وليالي أبطالها خلال تلك الملحمة وبعدها. ويبدو أن ذلك الخطاب القيمي الذي بقي (أبو أروى) وبعض رفاقه ملتزمين به عقب انتصارهم العسكري لم يكن متوفرا لدى بقية رفاق النصر، إذ مثل العمل السياسي اختبارا صعبا لذلك الانتصار؛ وهو الاختبار الذي انحرف بمسار الثورة، لتبدأ بأكل أبناء وقادة ذلك النصر في مسار مأساوي تتبعه الكاتب وهو يروي تساقط زملائه تحت جنازير انحراف ذلك التيار، الذي شكل ثورة مضادة كانت خلفيتها ثقافة مناطقية وطائفية، أهدرت أحلام الشعب، وتحولت معها الجمهورية إلى ما يشبه الغطاء لعمل عصبوي ظل ينهش الجسد اليمني، لدرجة استمر الانتقام وتواصل حتى بعد الموت، من خلال إخفاء جثث المعتقلين من أبطال ذلك النصر وصولا إلى محاولة سحل بعضها.
لا يمكن اعتبار الرواية تاريخية؛ فهي لم تكتب تاريخ مرحلة، بل حملت شهادة عنها بلسان أحد صناع الحدث، متضمنة رؤيته لما حدث.
في النصف الأول من الرواية تناول الكاتب طبيعة وخلفية تلك الملحمة، التي صنعت نصر فك الحصار في إنجاز لم يتوقعه العالم، وهو إنجاز صنعه توحد كل تيارات الجبهة الجمهورية، لكن تلك الوحدة الجمهورية التي صنعت النصر العسكري لم تصمد أمام العمل السياسي فانقسمت؛ وهو ما تناوله النصف الثاني من الرواية، وكم كان سرد تفاصيله مؤلما على الكاتب، وهو يروي سقوط رفاق المعركة، خاصة من تيار اليسار واحدا بعد الآخر، وصولا إلى القبض على (أبو أروى)، وهو طريح فراش المرض في أحد مستشفيات العاصمة، وبقي مصيره مجهولا كغيره ممن أخفوا قسريا وقتلوا في كواليس أجهزة الشرطة ودفنوا في مكان ما زال مجهولا، أيضا، حتى اليوم، فيما كانت نهاية (غُمدان) الذي فر إلى عدن من زوجته (وردة) أكثر مأساوية، حيث عكست مشاركتهما دور الشباب والمرأة في تلك الملحمة.
في عدن عاش (غُمدان) وضعا نفسيا صعبا جراء انعكاسات التحول المفاجئ في المشهد الثوري في صنعاء؛ وهو التحول الذي لم يستوعبه؛ فبقي يرزح تحت وطأته إلى أن اختار له الكاتب نهاية مختلفة مع زوجته في أحد سواحل عدن، حيث شاهدهما الناس وهما يحلقان بعيدا.
ميدان التحرير
أما (برهان) فوقف به الكاتب أمام مشهد مؤلم في ميدان التحرير؛ فبعد أن قرر الرحيل بعد أن رحل عنه أصدقاؤه، وخلال مروره من ذلك الميدان فوجئ بجماعة من أتباع الثورة المضادة يتحلقون حول جثة بطل فك حصار السبعين، عبد الرقيب عبدالوهاب ويطالبون بسحلها… وهو مشهد استفزه ليقف مخاطبا الناس، وكأن الكاتب أراد بذلك الخطاب أن يختزل رسالة مهمة من رسائل الرواية، قبيل أن يُقدِم بعض أولئك الرجـــــال على قتله؛ فينـضم (برهان) إلى قائــــمة الشهداء… ومما قاله (برهان) مخاطبا ذلك الجمع من الناس: «أهكـــذا تشهرون بالبطل الذي وقف سدا منيعا أمام جحافل الظلم والظــــلام؟ يا قوم هذا المكان يُدعى ميدان التحرير وليـــس ساحــــة المشانق والعــــبث بجثث الأبطال… هذا ميدان التحرير والعــــدالة والمساواة، وليس ساحة للحقـــد والكراهية والبغضاء، يجب أن يُقام، في هذا المكان، تمثال للشهيد البطل عبدالرقيب عبدالوهاب، وهناك يجب أن يرتفــــع تمــــثال قائد الثورة وبطلها الشهيد علي عبد المغني، وفي هذه الساحة التي سقط فيها الشهيد محمد مهيوب الوحش يجب أن يقام تمثال له… صنعاء يا جوهرة العرب كوني مدينة للأبطال والثوار، وليس مكانا للثأر والظلام. خلدي من دافع عنك، كرمي واحتضني من زارك».
كان الخطاب الروائي في هذا العمل واضحا ورشيقا في تعامله مع الأحداث والقضايا، وأظن أن الكاتب لم يهتم كثيرا بالأحداث بدليل أنه لم يورد أي تـــواريخ بقـــدر اهتمامه بالقضية. خلال سرده لما شهدته صنعاء قبل فـــك الحصار وبعده كان الكاتب حريصا على أن يشرك القـــارئ في فهم طبيعة الأحداث ويكسب تعاطفه مـــع تضحيات الثوار الأبطال وتسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى انحراف مسار العمل الثوري بعد الانتصار، وهناك سيفهم القارئ ماذا حصل ولماذا بقيت البلاد تعيش ما عاشته وتعيشه حاليا.
كان السرد جميلا، لاسيما والكاتب كان يشرك فيه الغناء والموسيقى والرقص، وكذلك الشعر من خلال الاستشهاد بأبيات من قصائد عبد العزيز المقالح، يوسف الشحاري، أحمد قاسم دماج، عبده عثمان وغيرهم.
كان الكاتب ساردا مبدعا وشاهدا حصيفا ومنصفا، كما أن توقيت صدور الرواية بالتزامن مع مـــا يعيشـــه البلد حالـــيا كأنــــه بذلك أراد أن يقول إن البلد يعيـــش حربــا أخرى منذ زمن، لاسيما إذا نظرنا إلى من يقف وراء ما يشهده من حرب راهنة؛ فتلك الدول التي حضرت في كسر انتصار اليمن في الستينيات هي نفسها تقف وراء أطراف الاحتراب اليوم مع اختلاف في التفاصيل.
يشار إلى أن الكاتب يشغل مقعد مندوب اليمن في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وله عدد من الكتب في السياسة والأدب.
مَن يقرأ رواية «درويش صنعاء» للكاتب والدبلوماسي اليمني أحمد الصياد، يشعر بأن الانتكاسة السياسية اليمنية التي أعقبت النصر العسكري لملحمة فك حصار السبعين يوماً عن صنعاء في ستينيات القرن الماضي، بقيت تنخر في جسد الجمهورية وتحُول بينها وبين التأسيس لدولة مدنية حديثة وصولاً إلى ما آلت إليه البلاد حالياً.
26 سبتمبر
تُمثل هذه الرواية الصادرة في 139 صفحة عن «دار العلوم ناشرون» في بيروت، شهادة جديرة بالقراءة المتأنية عن الحركة الوطنية الثورية اليمنية، التي أسهمت في فك حصار الملكيين والمرتزقة لصنعاء منذ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 1967 وحتى الثامن من فبراير/ شباط 1968؛ وهي الحركة التي أنقذت الجمهورية الوليدة في اليمن من موت محقق حينها، وأعادت الاعتبار لثورة 26 سبتمبر 1962، التي كانت على وشك الانكسار؛ ليمثل فك حصار صنعاء انتصارا لتلك الثورة، وتعميدا شعبيا لها، ذلك أن الشعب بكل فئاته وأطيافه ومناطقه شارك في صناعته، وبالتالي اكتسبت تلك الثورة بانتصارها العسكري صفتها الشعبية، إلا أن ما شهدته عقب انتصارها من انتكاسة سياسية، أصاب تلك الثورة في مقتل، من خلال ارتهان السلطة للثقافة الطائفية والمناطقية والفئوية؛ وهي الانتكاسة التي ظلت تستنزف عافية الجمهورية، وصولا إلى الحرب المستعرة حاليا، في ما صارت الجمهورية أشبه بعباءة لنهج عصبوي بقيت تتوارثه سلطة عقيمة.
كان الكاتب دقيقاً في حرصه على عدم تجاوز الواقع، وفي تماهيه ـتماماً- مع ما حدث، وكيف لا؟ وقد كان واحدا من صُناع ذلك الحدث، إذ كان حينها واحدا ممن أسهموا في فك الحصار، ولهذا لم نستغرب من كل ذلك الانثيال لمشاعر الحماس والفرح والألم في ثنايا الموقف الثوري، الذي بقي يفيض بغزارة بين سطور النص الروائي، ذلك أن الكاتب كان، وهو يكتب يعكس واقعا عاشه، ويكتب شهادته عنه؛ ولهذا نجد فلسفته للثورة تحضر في الحوار على ألسنة معظم شخوصها، التي شغلت حواراتهم معظم مساحة النص. وتظهر رؤية الكاتب واضحة في حديث (أبو أروى) في ما نرى حماسه وتطلعه في اندفاع وشجاعة (غُمدان) أما تماهيه القيمي مع الوعي الإنساني فجسدته شخصية (برهان) المتصوف.
الملحمة والمأساة
ارتكز بناء الرواية وحدثها الدرامي كثيرا على شخصية (برهان) الذي جاء منه اسم الرواية؛ فمعه، في (الجامع الكبير) في صنعاء، بدأ السرد، وباستشهاده في (ميدان التحرير) انتهت الرواية.
كان (برهان) القادم من خارج اليمن، شاهدا على (ملحمة الانتصار) و(مأساة الانكسار) التي أعقبت النصر، وقد استهلتْ به الرواية سردها في بيئة الملكيين داخل المدينة القديمة، بدءا بلقائه بالملكي الكهنوتي (حنتش)، ومن ثم انتقلت به الرواية بواسطة الشاب المقاوم (غُمدان) إلى بيئة المعسكر الجمهوري، وهناك في (بيت الجمهورية) الذي كان يلتقي فيه بعض قادة المقاومة الشعبية من أطياف اليسار اليمني على ما يبدو… عكست حوارات (أبو أروى) مع (برهان) الخطاب القيمي والفكري، الذي استند إليها ذلك المعسكر في ملحمته لفك الحصار عن مدينة. تنقلت الرواية بين يوميات وليالي أبطالها خلال تلك الملحمة وبعدها. ويبدو أن ذلك الخطاب القيمي الذي بقي (أبو أروى) وبعض رفاقه ملتزمين به عقب انتصارهم العسكري لم يكن متوفرا لدى بقية رفاق النصر، إذ مثل العمل السياسي اختبارا صعبا لذلك الانتصار؛ وهو الاختبار الذي انحرف بمسار الثورة، لتبدأ بأكل أبناء وقادة ذلك النصر في مسار مأساوي تتبعه الكاتب وهو يروي تساقط زملائه تحت جنازير انحراف ذلك التيار، الذي شكل ثورة مضادة كانت خلفيتها ثقافة مناطقية وطائفية، أهدرت أحلام الشعب، وتحولت معها الجمهورية إلى ما يشبه الغطاء لعمل عصبوي ظل ينهش الجسد اليمني، لدرجة استمر الانتقام وتواصل حتى بعد الموت، من خلال إخفاء جثث المعتقلين من أبطال ذلك النصر وصولا إلى محاولة سحل بعضها.
لا يمكن اعتبار الرواية تاريخية؛ فهي لم تكتب تاريخ مرحلة، بل حملت شهادة عنها بلسان أحد صناع الحدث، متضمنة رؤيته لما حدث.
في النصف الأول من الرواية تناول الكاتب طبيعة وخلفية تلك الملحمة، التي صنعت نصر فك الحصار في إنجاز لم يتوقعه العالم، وهو إنجاز صنعه توحد كل تيارات الجبهة الجمهورية، لكن تلك الوحدة الجمهورية التي صنعت النصر العسكري لم تصمد أمام العمل السياسي فانقسمت؛ وهو ما تناوله النصف الثاني من الرواية، وكم كان سرد تفاصيله مؤلما على الكاتب، وهو يروي سقوط رفاق المعركة، خاصة من تيار اليسار واحدا بعد الآخر، وصولا إلى القبض على (أبو أروى)، وهو طريح فراش المرض في أحد مستشفيات العاصمة، وبقي مصيره مجهولا كغيره ممن أخفوا قسريا وقتلوا في كواليس أجهزة الشرطة ودفنوا في مكان ما زال مجهولا، أيضا، حتى اليوم، فيما كانت نهاية (غُمدان) الذي فر إلى عدن من زوجته (وردة) أكثر مأساوية، حيث عكست مشاركتهما دور الشباب والمرأة في تلك الملحمة.
في عدن عاش (غُمدان) وضعا نفسيا صعبا جراء انعكاسات التحول المفاجئ في المشهد الثوري في صنعاء؛ وهو التحول الذي لم يستوعبه؛ فبقي يرزح تحت وطأته إلى أن اختار له الكاتب نهاية مختلفة مع زوجته في أحد سواحل عدن، حيث شاهدهما الناس وهما يحلقان بعيدا.
ميدان التحرير
أما (برهان) فوقف به الكاتب أمام مشهد مؤلم في ميدان التحرير؛ فبعد أن قرر الرحيل بعد أن رحل عنه أصدقاؤه، وخلال مروره من ذلك الميدان فوجئ بجماعة من أتباع الثورة المضادة يتحلقون حول جثة بطل فك حصار السبعين، عبد الرقيب عبدالوهاب ويطالبون بسحلها… وهو مشهد استفزه ليقف مخاطبا الناس، وكأن الكاتب أراد بذلك الخطاب أن يختزل رسالة مهمة من رسائل الرواية، قبيل أن يُقدِم بعض أولئك الرجـــــال على قتله؛ فينـضم (برهان) إلى قائــــمة الشهداء… ومما قاله (برهان) مخاطبا ذلك الجمع من الناس: «أهكـــذا تشهرون بالبطل الذي وقف سدا منيعا أمام جحافل الظلم والظــــلام؟ يا قوم هذا المكان يُدعى ميدان التحرير وليـــس ساحــــة المشانق والعــــبث بجثث الأبطال… هذا ميدان التحرير والعــــدالة والمساواة، وليس ساحة للحقـــد والكراهية والبغضاء، يجب أن يُقام، في هذا المكان، تمثال للشهيد البطل عبدالرقيب عبدالوهاب، وهناك يجب أن يرتفــــع تمــــثال قائد الثورة وبطلها الشهيد علي عبد المغني، وفي هذه الساحة التي سقط فيها الشهيد محمد مهيوب الوحش يجب أن يقام تمثال له… صنعاء يا جوهرة العرب كوني مدينة للأبطال والثوار، وليس مكانا للثأر والظلام. خلدي من دافع عنك، كرمي واحتضني من زارك».
كان الخطاب الروائي في هذا العمل واضحا ورشيقا في تعامله مع الأحداث والقضايا، وأظن أن الكاتب لم يهتم كثيرا بالأحداث بدليل أنه لم يورد أي تـــواريخ بقـــدر اهتمامه بالقضية. خلال سرده لما شهدته صنعاء قبل فـــك الحصار وبعده كان الكاتب حريصا على أن يشرك القـــارئ في فهم طبيعة الأحداث ويكسب تعاطفه مـــع تضحيات الثوار الأبطال وتسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى انحراف مسار العمل الثوري بعد الانتصار، وهناك سيفهم القارئ ماذا حصل ولماذا بقيت البلاد تعيش ما عاشته وتعيشه حاليا.
كان السرد جميلا، لاسيما والكاتب كان يشرك فيه الغناء والموسيقى والرقص، وكذلك الشعر من خلال الاستشهاد بأبيات من قصائد عبد العزيز المقالح، يوسف الشحاري، أحمد قاسم دماج، عبده عثمان وغيرهم.
كان الكاتب ساردا مبدعا وشاهدا حصيفا ومنصفا، كما أن توقيت صدور الرواية بالتزامن مع مـــا يعيشـــه البلد حالـــيا كأنــــه بذلك أراد أن يقول إن البلد يعيـــش حربــا أخرى منذ زمن، لاسيما إذا نظرنا إلى من يقف وراء ما يشهده من حرب راهنة؛ فتلك الدول التي حضرت في كسر انتصار اليمن في الستينيات هي نفسها تقف وراء أطراف الاحتراب اليوم مع اختلاف في التفاصيل.
يشار إلى أن الكاتب يشغل مقعد مندوب اليمن في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وله عدد من الكتب في السياسة والأدب.

