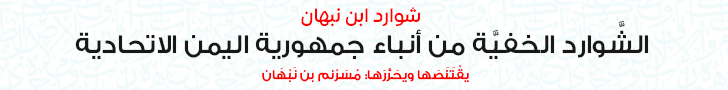الجبهة الوطنية الديمقراطية والجبهة الإسلامية.. د. عادل الشجاع عن"عقلان"
السياسية - Monday 28 December 2020 الساعة 10:40 am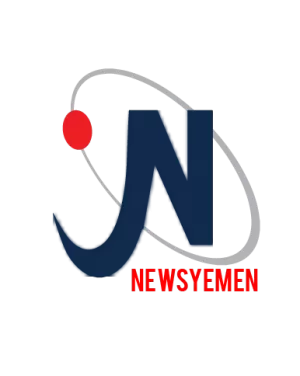 نيوزيمن، كتب/ د. عادل الشجاع:
نيوزيمن، كتب/ د. عادل الشجاع:
بداية نتوقف بين "الشعرية والثنائيات المبثوثة في الرواية"، ففي كتاب (موريس ميرلو بونتي) "المرئي واللا مرئي" الذي يعيد صياغة علاقة الوجود بالموجود، من خلال الرؤية التي تربط بين الذات المدركة والعالم، حيث تقع الرؤية في صميم التفاصيل بين الذات ووعيها بالعالم الذي تنتمي إليه.
تجمّع العالم الخارجي المحدد في الزمن والمكان مع العالم الداخلي الحاضر في الذهن، حيث تمارس الرؤية حضورها بين المرئي واللا مرئي، لأن الوعي بالحقيقة يتجسد بالوعي الحسي بعيدًا عن متاهة المتخيل.
إذا كان العقل هو ما يفترض بالذات أن تفهم العالم من خلاله فإنها هنا تستوعبه بالعين وتستوعبه كذلك بالجسد المادي والتفاعل مع ما هو موجود بالاتصال المباشر.
كاتب رواية عقلان يريد أن يصنع الرؤية في المقام الأول بوصفها أمرًا مهمًا في تأكيد الإدراك ليتمكن العقل من الاشتغال في مرحلة تالية.
ولذلك جاء عنوان الرواية عقلان مرتبطا بشخصية أساسية داخل الرواية وهو عمر عقلان.
يتعزز التشاكل الذي يرسخه النص في البداية في ثنائية "الحضور والغياب" حيث يقول الكاتب بداية العمل على لسان عمر وهو الذي كما قلتُ تدور حوله الرواية. بيدي وهو يجيب على سؤال أمه وهي تحتضنه بين ذراعيها والخوف يلفها خوفًا من أن يتعرض للقتل وتريد أن تمنعه من ممارسة نشاطه أو ممارسة العمل في مواجهة الأحداث الجارية في المنطقة.
هو يقول: "إذا فشلت فيمكنني الغياب.. الغياب أول خيوط الحكمة وآخر حروف الصبر فلاجل أمه قد يفعل كل شيء".
نلاحظ أن الثنائيات سجلت حضورًا لافتًا في هذه الرواية، هذه الثنائيات لم تكن مجرد جمع بين قطبي الثنائية في تركيب لغوي واحد بل شكلت مسافة التوتر الذي يتناسب مع الشعرية الطاغية على النص، ولا شك أن هذه الثنائيات أضفت على النص صبغة جمالية وجعلته مفتوحًا على تعدد القراءات.
من الواضح أن الكاتب تعرض إلى تيارين شعريين متساويين في الشدة من خلال هذه الثنائيات، أو هذه الثنائيات انعكست على الشعورين المتساويين اللذين كانا يحركان الكاتب.
هذان الشعوران المتباينان في الوجهة تنازعا إحساسه فظهر أحدهما واعيًا والآخر ظل حبيس اللا وعي، بمعنى أن الثنائيات المبثوثة في النص كان إحداها يستثمر نظام الإدراك في الوعي والثاني ظل في اللا وعي، وهي أي الثنائيات تعد بنية لغوية متقاطعة اللفظ والمعنى وكما يعرف النقاد والفلاسفة الثنائيات: "بأنها مصطلح يقوم على الربط بين الظواهر المنفصلة والترابط بينها" فهي تنشأ من شعورين مختلفين.
لعل هنا كان ناتجا عن تجربة الكاتب الذي عاش في بيئة فرضت معظم معطياتها نمطًا معيشيًا أيقظ عنده احساسين متضادين هما الشعور بالذات والشعور باستلابها في الوقت ذاته.
رواية عقلان طرقت بابًا جديدًا ربما لم يطرقه الروائيون اليمنيون من قبل، وقد تطرقت لفترة زمنية شديدة الخصوصية في تاريخ اليمن.
من يعرف تاريخ اليمن هو يعرف مرحلة السبعينات والثمانينات التي انتشر فيها "الجبهة الوطنية الديمقراطية" وبمقابلها "الجبهة الإسلامية" بعد أن خاضت الجبهة الوطنية حروبًا مع الدولة أو مع السلطة في ذلك الحين وعجزت السلطة عن مواجهتها، فصنعت الجبهة الإسلامية لمواجهة الجبهة الديمقراطية المتمثلة باليسار الذي كان يعمل لصالح الجمهورية اليمنية الديمقراطية في الجنوب قبل الوحدة.
وبالتالي لم يطرق هذا الباب أي من الروائيين اليمنيين بالرغم من المادة الكثيفة الموجودة والمساعدة لكتاب الرواية أن يبدعوا في هذه المرحلة التاريخية من الصراع اليمني، ولم يلج إلى هذه المنطقة في اعتقادي سوى هذه الرواية التي بين أيدينا التي ركزت على مرحلة الصراع في المناطق الوسطى الممتدة بين محافظتي إب وتعز.
فقد فرضت على الكاتب أسئلة الذات وجدلية الكينونة والعدم فهي مرحلة الصراع بين اليمين الديني واليسار الاشتراكي، اتخذ الكاتب من الثنائيات الضدية سلمًا لإثارة العديد من القضايا التي اتكأت على نقضيها في الوقت ذاته.
وبالإضافة إلى ثنائية الحضور والغياب فقد سجلت ثنائيات "الموت والحياة، الوجود والعدم" والرواية تقوم أيضًا على فصلين اثنين، هناك عناوين متعددة لكن الرواية انقسمت إلى فصلين اثنين أي أن الرؤية موجودة في الرواية شكلًا ومضمونا.
نجد الموت يزاحم الحياة في رواية عقلان وهذا ربما يعود إلى خصوصية الفترة التي عاشها السارد ومن ورائه الكاتب الذي عبر عن قلقه إزاء الموت الهمجي، الذي يصادر حقوق الناس في البقاء ويحول الحياة إلى عبث يفقد الإنسان إحساسه الفطري بكينونته، هذا ما دفع الكاتب إلى الإقرار في صفحة 10 "بأن الحياة تسرق منا نصف القرار حتى ونحن على وشك النضوج، هي غريزة تكتمل باكتمال النضوج حيث يصبح القرار كله بيدها وحدها وحينها لا ينفع معها التراجع.. تنصت لنصائح من حولك سرعان ما تنسى كل ذلك عند تجاوزك لعتبة الباب الذي ستخرج منه بقدميك قد لا تعود منه مرة ثانية إلا محمولًا، يحيط بك نواح المكلومين وحسرة لن تدوم طويلًا لأن التالي سيخلفك في السقوط فلا سبيل لإرضاء الحياة".
فبدلًا من أن تستحوذ الحياة على تفكير الإنسان نجد هنا أن الموت هو الذي يترك ذلك في اللا وعي، وتتجه الحركة نحو الموت، تنقلب المعادلة هنا حيث يبرز الموت بوصفه أحد أقطاب الثنائية بينما يبقى القطب الآخر هي الحياة مستترة في موطن آخر، يتوازى خط الحياة مع خط الموت يقول الراوي في صفحة 84، "حتى يتسع الكون للجميع لا بد من الموت والموت من سننه أنه لا يأتي بصورة واحدة.. القتل جزء من الموت وحالة ضرورية بين الكائنات.
هنا تزول الحياة الفاصلة بين الحياة والموت بل قد يصبح الموت ضرورة لكي تستمر الحياة وهذا يقود الكاتب إلى طرح سؤال فلسفي ففي صفحة 105 يقول: "أيهما يقوم بالانجذاب إلى الآخر لإثبات زعامة الحياة الأخرى الروح إلى الموت أم الموت إلى الروح ".
شخصيات الرواية ملتصقة بالواقع المجتمعي أشد الالتصاق، وقد حاول الكاتب أن يظهر السلبية الثقافية التي تعيشه شريحة من المجتمع وهي بدورها من إرهاصات العمل الحزبي السري في ذلك الوقت.
رواية عقلان غنية بشخصيات وتباين أفكارهم ومواقعهم جراء الأمور التي تجري، هذه الرواية تماثل الواقع المعاش وهناك شخصيات رئيسية تتمحور الرواية حولها، وشخصيات ثانوية تظهر في مسرح الأحداث بين الحين والآخر، وهناك السلبي والبطل الإيجابي والبطل الحقيقي الخيالي.
حينما كان الكاتب يكتب عن مرحلة تاريخية إنما فعل ذلك وعينه على الحاضر لا شك في ذلك، وقد لجأ إلى التاريخ بوصفه تجربة مكتملة منتهية يسهل تقويمها واستخلاص العبرة منها والاعتماد عليها أيضًا في الحكم على الحاضر وتوجيهه الوجهة السليمة.
قدم مسألة العلاقة بين الراعي والرعية من خلال الشيخ عماد لكن الواقع كان يناقضه من خلال العلاقة بين السلطة والرعية، حيث ظهرت السلطة في ممارستها أنها غريبة عن الأرض والشعب وسلوكها يمثل سيفا مسلطا على رقاب الناس.
خلاصة القول كان يمكن لهذه الرواية أن تأخذ شكلا آخر لو أن الكاتب قرأ الفترة التاريخية التي كتب عنها بتمعن، ولو أنه قرأ على الأقل الصحف الصادرة في تلك الفترة، لبنى من خلالها رواية بديعة تتسم بالأحداث التاريخية التي تقارب الواقع، لأن هذه الرواية هي رواية تاريخية واقعية وهي كانت تحتاج إلى رؤيا من زاوية أخرى ربما كانت ستكون أكثر غنى.
لكن الكاتب هو خريج فلسفة وشاعر وربما اللغة الشعرية طغت على لغة الرواية وعلى السرد بما جعل الرواية تتضخم بهذا الحجم، وكان يمكن أن تكون الرواية أصغر من ذلك هناك الكثير من المقاطع إذا حذفت من هذه الرواية لن تؤثر عليها في شيء لأن السرد غير متراكم، لذلك اللغة الشعرية مكثفة فظهر السرد بطيئا من حيث القفز إلى الأمام ثم العودة إلى نفس النقطة التي انطلق منها وظهرت الأحداث وكأنها حدث واحد.
عنوان الرواية عقلان التي نجد شخصية الرواية عمر عقلان تشيء بشيء من عبثية تلك الشخصية، وحضوره لم يكن سوى مجرد لعبة يلعبها الكاتب مع القارئ لأن هذه الشخصية أيضًا لم تأخذ محورا كبيرا داخل الرواية ولم تأخذ محورا رئيسيا برغم أنها هي المحور الرئيسي في عنوان الرواية، خاصة أننا نكتشف أن هناك ذاتا أخرى تتوازى مع عمر عقلان هي الذات الروائية أو الذات الراوية.
فعقلان الذي ظهر في بداية الرواية دمًا ولحمًا يعانق أمه ظهر في آخر الرواية ظلًا أو شبحا.. يقول الكاتب "تركتْ عكازًا في الظل إلى جانب عقلان وفصولًا مشتتة". وبالتالي عقلان الذي كان دما ولحما يحتضن أمه في بداية الرواية، تحول في آخر الرواية كأنه كان هذه الرواية ذاتها أو الفصول المشتتة الموجودة داخلها.
كان المتخيل أعلى من الواقعي بالرواية لكنه كان خيالًا شعريًا أكثر منه فنتازيا أو خيالًا غرائبيًا أو عجائبيًا.
اللغة الشعرية أحرمت الراوي من الإطلالة الزمنية والمكانية وغيبت التنوع وكذلك غيبت التتابع الزمني والتسلسل المنطقي للأحداث.
لعل من أهم ما يقف عنده القارئ من محطات تلك العلاقة الحميمية غير المتكافئة بين (عزيز وفائزة) وكأن الكاتب يرغب في العودة إلى الصبا فتوقف الزمن عند هذه المرحلة، نجد أن شخصية عزيز منذ بداية الرواية وحتى آخرها وهو الطفل الصغير الذي لم يكبر ولم يتحول بتحول الزمن وتحول الأحداث، وبالتالي أيضًا فائزة ظلت تلك راعية الغنم التي تقرأها في آخر الرواية كما تقرأها أيضًا في أولها، انتهت وعزيز لم يغادر بعد محطة روايته.
فالسمة البارزة كما قلت في هذه الرواية هي الشعرية، فقد استخدم الكاتب اللغة استخدامًا خاصًا فتمرد على العادي منها أو المألوف، ووظف كل الانزياحات الممكنة على مستوى اللفظ والمعنى؛ لكنه أخفق في تفعيل الزمان وتفعيل المكان، وكان بإمكان (الزمان والمكان) أن يكونا بطلين أساسيين في هذه الرواية.
* ورقة نقدية قدمها الكاتب في فعالية "أروقة بوك" الاحتفالية بالرواية في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة 25 ديسمبر 2020